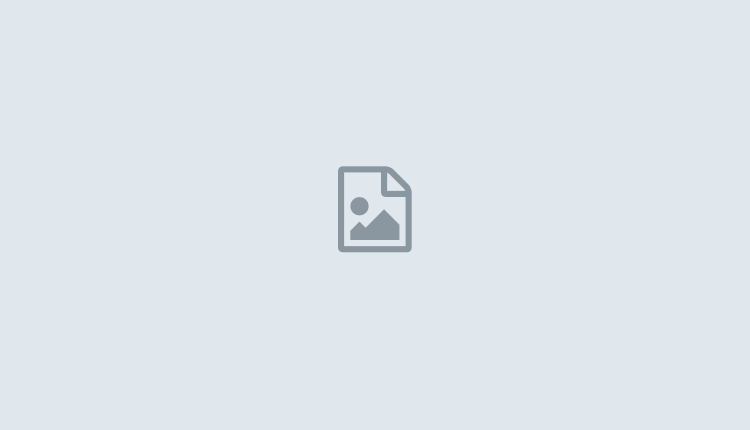ما قبل وبعـد الترسيم الأمريكي للتطبيع الصهيوإماراتي
ذمار نيوز || مقالات ||
[2 سبتمير 2020مـ -13محرم 1442هـ ]
كتب / عبدالله علي صبري
رغمَ أن العلاقاتِ الخفيةَ والعلنيةَ بين الإماراتِ والكيانِ الصهيوني كانت تُفصِحُ في كثيرٍ من مساراتِها عن التطبيعِ شبهِ الكامل بين الدولتين، إلا أن وَقْــــعَ الإعلانِ الرسميِّ عن الخيانة الإمارتية للأُمَّـة وللقضية الفلسطينية كان صادماً، خَاصَّةً أن الإعلانَ قد جاء من واشنطن، وفي إطارِ خدمةٍ دعائية لأسوأِ رئيسٍ أمريكي تعامَلَ باستهتار كبير مع العرب ومع ثرواتهم وحقوقهم وقضاياهم، وبنوعٍ من الوقاحة غير مسبوقة في البروتكولات السياسية والدبلوماسية.
هان حُكَّــامُ أُمَّتِنا، فسَهُــلَ الهوانُ علينا للأسف الشديد، وباتت قضايا الأُمَّــة الكبرى والمصيرية تُباعُ على أرصفةِ النخاسة جهاراً نهاراً، وكأنَّ الوطنَ العربي معمَلُ تجارِبَ لقوى الهيمنة التي لم تغادرْ حقبةَ الاستعمار والاحتلال إلَّا من ناحية الشكل، وإلَّا فإنَّ معظمَ العواصم العربية غدت مسلوبةَ الكرامة والقرار، وأضحى حكامُها مُجَـــرَّدَ دُمَىً على مسرح الصراع الدولي، وقفازات رخيصة الثمن بيد الفاعل الأمريكي، حتى وإن استعرضوا على شعوبهم أدوارَ الفخامة والجلالة.
وهكذا، فإنَّ الإعلانَ الإماراتي عن التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني لا يُعَبِّــرُ عن شيءٍ جديد أَو مفاجئ. ومنذُ توقيع “اتّفاق كامب ديفيد” بين مصر وإسرائيل، فإنَّ منحنى خيانةِ القضية الفلسطينية في تصاعُدٍ مستمرٍّ، ولا يبدو أنه سيتوقفُ على المدى المنظور، فكيف حدث مثل هذا ولماذا يحدُثُ ونحن أُمَّـة كانت لوقت طويل في صدارة العالم قوة وحضارة ومجداً؟
دولتان وظيفيان
بالعودة إلى الماضي القريب، سنعرفُ أن بريطانيا هي من تبنَّى بشكل رئيسي تقسيمَ الوطن العربي إلى الدويلات الحالية، وتحويله إلى مسرح للصراعات الداخلية والخارجية التي لم تتوقفْ منذُ سايكس- بيكو، وحتى الإعلان الأمريكي عن تصفية القضية الفلسطينية في إطار مشروع “صفقة القرن” الذي تأتي الخطوة الإماراتية الأخيرة، لتكشفَ مدى جاهزية غالبية الأنظمة العربية للهرولة إلى الحُضن الإسرائيلي تحت مزاعم “السلام” وفزَّاعة “الخطر الإيراني”.
حينَ غرست بريطانيا الكيانَ الصهيوني كخنجرٍ مسمومٍ في قلب العالم العربي، فإنَّها قامت بعملٍ مماثلٍ عندما اصطنعت الوهَّـابيةَ السعوديةَ في قلب الجزيرة العربية. وما إن استقر الكيانان المدعومان بريطانياً ثم أمريكياً، حتى أكملت قوى الهيمنة تثبيت الإمارات النفطية في منطقة الخليج العربي، وربطها بالنظام الرأسمالي الغربي وبتوجُّـهات واشنطن إبَّانَ وبعد الحرب الباردة.
ولأَنَّ السياسةَ الأمريكية في منطقتنا قامت وتقومُ على حماية النفط وإمدَاداته إلى الشركات والمصانع الغربية، وعلى حماية إسرائيلَ وضمانِ أمنها ووجودها، وتفوقها، فقد لعب حكامُ السعودية وإماراتُ الخليج دوراً كَبيراً في تحقيق الأهداف الأمريكية، وضمان مصالح الرأسمالية المتوحشة، مع فارقِ أن الجيلَ الأولَ من الحكام كان لا يزالُ يملكُ مساحة من المناورة، والاحتشام السياسي إنْ جاز التعبير، على عكس ما نراه اليومَ مع أولاد زايد وسلمان، والحاكمين الفعليين في الرياض وأبوظبي، محمد بن سلمان ومحمد بن زايد.
صحيحٌ أن مصر والأردن كانتا السباقتَين في الخيانة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتبادل الاعتراف والتمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب، إلا أن عواصمَ عربيةً أُخرى انتهجت خطواتٍ شبيهةً، وذلك بُــعَــيْــدَ اتّفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وكيان الاحتلال 1993م، حيثُ رحّبت المغرب وقطر وعُمان وتونس بفتح مكاتبَ تجاريةٍ لإسرائيل، بعضُها لا يزالُ قائماً ويمارسُ أدوارَ الخيانة على العلن.
وخلالَ فترة ما قبل “الربيع العربي” لعبت قطر دوراً محورياً في تنفيذ السياسات الأمريكية بالمنطقة، وبرزت الدوحةُ من خلال ذراعِها الإعلامي “الجزيرة”، وكأنَّها دولةٌ عظمى تهابُها بقيةُ الدول، وتبادرُ إلى التقرُّب منها، كجسر عبور إلى واشنطن وتل أبيب، وكقبلة للريال القطري، والتلميع السياسي والإعلامي. ولَمَّا حَـلَّ ما يُعرَفُ بثورات الربيع العربي، كان “الإخوان المسلمون” بمثابة الذراع الثاني لقطر، المَرْضي عنه أمريكياً، الأمرُ الذي أثار مخاوفَ مملكات وإمارات الخليج الأُخرى، التي سارعت إلى مواجهةِ المد الثوري حول الحزام الخليجي، لكن ضمنَ تفاهمات مع الجانب الأمريكي أَيْـضاً.
تضخمت فزَّاعتا “المَدِّ الثوري” وَ”الخطر الإيراني”. واستلمت الإماراتُ الرايةَ الأمريكيةَ بدلاً عن قطر في ظل مباركة سعودية- مصرية، وُصُـولاً إلى إعلانِ التحالف العربي لما يسمى بـ “عاصفة الحزم”، وسطَ تقاطع جملة من الأهداف الداخلية والخارجية مع طموحات بن سلمان في القفز السريع إلى العرش الملكي.
في قلبِ المشروع التفكيكي
في الخضم، ظهر مصطلحُ “إسرائيل السُّنية” في مقابلِ “إيران الشيعية”، وأمكن للمشروع الصهيوأمريكي التمدُّدُ أكثرَ وأكثرَ على حسابِ محور المقاومة والممانعة، الذي تشكّل من قوىً وحركاتٍ إسلاميةٍ ووطنيةٍ في فلسطين ولبنان، تحظى بدعم من سوريا العروبة، وإيران المقاومة.
ورغم تراجُعِ الأنظمة العربية عن دعم القضية الفلسطينية كمحورٍ للصراع الوجودي مع الكيان الغاصب، إلا أن التياراتِ الشعبيّةَ العربيةَ كانت -حتى وقت قريب- تفيضُ حماسةً ودعماً للشعب الفلسطيني، ولكل حركات المقاومة، وللموقف الإيراني المؤازر لحقوق العرب، إلا أن المشهدَ تغير إلى حَــدٍّ كبير بُعَيْدَ انتصارِ المقاومة اللبنانية في أغسطُس- تموز 2006م، فمع مباشَرة العدوان الصهيوأمريكي على لبنان، بشّرت كونداليزا رايس أصدقاءَها في المنطقة بشرق أوسط جديد، تكونُ الغلَبَةُ فيه لإسرائيلَ ومَن يدورُ في فلكها.
غيرَ أن صمودَ الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة، أفشل رهاناتِ العدوان، ومنح محورَ المقاومة زخماً أكبرَ كان بالإمْكَان استثمارُه عربياً، لولا النغمةُ الطائفية التي جرى إطلاقُها وتصويبُ سهامها نحو “حزب الله” ضمنَ خطة أمريكية، استهدفت محاصَرةَ محور المقاومة، وإعادةَ الفرز بين دول وشعوب المنطقة على أَسَاسٍ “طائفي”.!
ويوماً بعدَ يوم وإثر الضخ الإعلامي المتواصل وارتهان غالبية الحكام العرب، تغيَّرت المفاهيمُ والمصطلحاتُ، وبات أنصافُ الساسة والمثقفين يرسُمُون أيديولوجيا العِداء باتّجاه إيران، بدَلاً عن إسرائيل التي أصبحت بمثابة الصديق المأمون جانبُه لدى بعض العرب. وهكذا غدا الحديثُ عن مظلومية وعدالة القضية الفلسطينية، جزءاً من أحلام الماضي، وبات علينا التعاطي مع منابرَ وأبواقٍ تتلفَّعُ رداءَ الواقعية، وتحتشدُ باتّجاه الوقيعةِ بين حركات المقاومة وحاضنتِها الشعبيّة، في تراجيديا عربيةٍ تبعثُ على المرارة والأسى، وتُنذِرُ بما هو أسوأُ وأخطر.
وكما كان المشروعُ البريطاني قائماً على تقسيم وتجزئة تركة الرجل المريض، فإنَّ المشروعَ الصهيوأمريكي اليومَ يقومُ على تجزئة المجزَّأ، وتفكيكِ الدول العربية، وتفجيرِها من الداخل، بما يجعلُ من إسرائيلَ الدولةَ الأكثرَ نفوذاً واستقراراً وهيمنةً في المنطقة، مع فارقِ أن رموزَ الثورة العربية الكبرى كانوا بالأمس في غفلةٍ عن المخطّط البريطاني، على عكس غالبيةِ الحكام العرب اليوم، الذين يجتهدون ويتنافسون في سبيلِ إرضاءِ واشنطن وتل أبيب على حسابِ الكرامةِ والمصلحةِ العربية والوطنية.
ما بعدَ التطبيعِ الرسمي
بالنسبة للإمارات، فقد انطلق حكامُها خلالَ العشرية الأخيرة وراء أحلام اليقظة، التي صورت لهم أن المالَ وحدَه يصنعُ الدولَ ويحمي العروشَ، فإذا أضيف له الحمايةُ الأمريكية، فهذا يعني –بنظرهم- أن الحلمَ قريبُ المنال، وأن الدورَ الوظيفي للحاكم “الكومبارس” يمكنُه أن يترقَّى فيصبح بطلاً في فيلم “أكشن”، رديء السيناريو والإخراج.
هكذا يمكنُ تفسيرُ التدخلات الإماراتية العسكرية في مصر وليبيا واليمن، وصراعها العلني مع دول كبرى كالصين، وإقليمية مثل تركيا وقطر، وانخراطها في حرب الموانئ على امتداد البحر الأحمر والقرن الأفريقي وشرق المتوسط.
ولأنَّها لا تضمَنُ التقلباتِ داخلَ الإدارة الأمريكية، تتوخَّى الإماراتُ من خطوةِ التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني تأمينَ مصالحِها التجارية والاقتصادية في مناطقِ نفوذها خارجَ بلادها، بالنظرِ إلى أن الحزبَين الرئيسَين في الولاياتِ المتحدة يدعمان إسرائيلَ ويحظيان في المقابلِ بمباركة اللوبي الصهيوني المتغلغلِ في مؤسّسات الدولة الأمريكية ووسائل الإعلام فيها.
وقبل ذلك، شرعت الإماراتُ في تعزيز علاقاتها بروسيا الاتّحادية، وذلك في إطارِ هاجِسِ التأمين نفسِه، الذي سيبقى مرافِقاً لهذه الدويلة الاصطناعية ما دامت سياستُها على الضدِّ من المصلحة العربية المشتركة والقضايا المصيرية للأُمَّـة.
الكيانُ الصهيوني هو الآخرُ يلعَبُ على حبل التوازُنات الدولية، وكما انتقل من الحُضن البريطاني إلى الأمريكي، فإنَّ اللوبي اليهودي حاضرٌ وبقوة في كثيرٍ من العواصم العالمية الكبرى، بما في ذلك موسكو وبكين، ولن يجدَ حرجاً في القفز من السفينة الأمريكية وهي على وشك الغرق والانهيار.
بَـــيْـــدَ أنَّ الحساباتِ الصهيوإماراتية تغفَلُ عن حقيقةِ أن القضيةَ الفلسطينيةَ راسخةٌ في وجدانِ الشعبِ العربي، ومهما بلغ حجمُ الخِــذلان للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، فإنَّ حركاتِ المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها عصيةٌ على الانكسار. وكما أن الفجرَ يعقبُ الليلَ حالكَ الظلام، فإنَّ الشعوبَ الحيةَ لا تموتُ وإن غلبها الكَـرَى، ولا تخضعُ أَو تستسلمُ وإن استبد بها العجزُ وأثخنتها جراحُ الخِيانات.